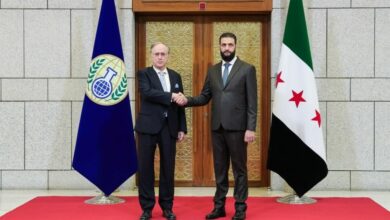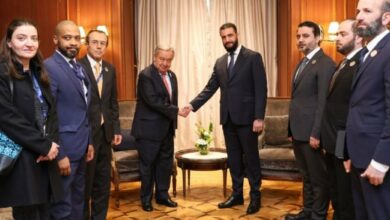ركوب الحافلات ست عشرة مرة، المشي في الشوارع العامة، التجول بين الأسواق وعربات النقل والاقتراب من عناصر الأمن والشعب.. كلها أحداث اعتيادية بالنسبة إلى السوريين في المهجر، لكن بالنسبة لي كلاجئ منذ أربع سنوات فهي حرب كنت قد خضتها لأول مرة الشهر المنصرم.
أربع سنوات مضت مذ غادرت سوريا، لكنها وعلى مايبدو لاتزال غير كافية للاندماج مع الحياة الجديدة، الحياة الخالية من القصف والقتل والمعارك، إذ لا يزال الخوف والحذر من كل شيء يسيطران علي، فحتى اليوم أخشى التبضع من سوق الخضار “البازار”، كما أخاف من الانتظار عند موقف عربات النقل الداخلي، أتوجس من البزات الرسمية الحكومية بمختلف أشكالها وأخاف سيارات الشرطة.
سنتان وأنا أكافح للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة، حتى حصلت عليها بعد عشرات المحاولات وكثير من الذهاب والإياب وجمع الأوراق وغيرها من الإجراءات البيروقراطية.. واليوم هي في جيبي، ورغم معرفتي التامة بأنها رسمية لا تشوبها شائبة، لكن لاأزال أخشاها .. لا أدري لماذا، لكن هو القلق والخوف.
قبل سنة تم إيقافي لدقيقة أو أقل من قبل عنصري شرطة دققوا هويتي ومضيت في طريقي، لكن الدقيقة كانت كافية للتسبب بانخفاض ضغطي وانهياري من الداخل .. وتذكر لحظة احتجازي من قبل حاجز نظام الأسد عند “مقبرة النقارين” بريف حلب الشرقي وانتظاري لحظة سوقي إلى المجهول، كما أني وإلى الآن أرفض التوجه إلى المشفى رغم أنني دخلتها مكرهًا عدة مرات، لكن الخشية من المجهول تجعلني أتردد في القيام بأي شيء يتطلب إبراز بطاقة (السوري) التي أحملها.
أجدني مجبراً على البقاء حبيس المنزل معظم الوقت، لا أجلس طبعاً في غرفة العائلة المطلة على الشارع، بل اخترت غرفة داخلية لامتنفس لها، وأناجز أهلي من استئجار منزل عال عن الأرض، أما خروجي للتسوق من البازارات فيكاد يكون معدوماً لولا خروجي مكرهاً مرتين فقط خلال السنوات الماضية، وعندما أجبرت للخروج فإن فكرة أن استقل الحافلة لم تكن من خياراتي طالما أن المسير أقل من ساعة مشياً على الأقدام، والتنقل قطعاً يكون بين الأزقة الفرعية الضيقة لا العامة.
كل ذاك الخوف هرب معي من سوريا، وأخذت سلوكياته حيزاً كبيراً من عقلي، وسيطرت على أفعالي وعاداتي، فهي مرتبطة بالقصف والمجازر المتعمدة التي كان يحدثها نظام الأسد، مجازر سوق الشعار، سد اللوز، طريق الباب، الفردوس، المشهد وغيرها الكثير، ومجازر كراج جسر الحج والحيدرية ومواقف العربات في الشعار واستهداف الطرق في الصاخور وغيرها من الطرق، كلها بالنسبة لي مجازر قوات “السلطة والحكومة”، حتى آمنت أن ممثلي “الدولة” كلهم متشابهون بالفكر ويجب الخوف منهم.
لكن كما هي العادة هناك غطاء لتخفيف حدة كل شيء، وغطاء الخوف لدي هو المطر، والغيوم السوداء، ففي كل مرة أخرج فيها من المنزل أتعمد أن تكون بيوم ماطر أو مغلفة سماؤه بسحبٍ سوداء تنذر بالمطر، فكل تنقلاتي التي قمت بها الشهر الفائت كانت تحت رحمة المطر والغيوم المسودة، وللأمانة لم ألحظ الأمر حتى أيام قليلة، عندما رفضت الذهاب إلى موعد هام لمجرد فقط أنه يوم مشمس.
حتى هذا الغطاء الذي قد يجده البعض غريباً، إلا أنه كان لسنوات أفضل مايمكن أن نحصل عليه نحن الحلبيون والسوريون، فالمطر والريح والضباب، الضباب أجمل ما يمكن أن نحصل عليه، فهو يعني غياب الطائرات عن سمائنا، ويعني انخفاض حدة القصف البري، فيصبح نقل البضائع من الطرق الواصلة بين الريف والمدينة أسلم، والتجمعات تكون آمنة أكثر من الأيام المشمسة، إذ تتيح الحركة دون الخوف من برميل هاو أو حاوية متفجرة أو صاروخ فراغي أو بالستي أو قذائف تنهمر مثل المطر.. معها يكون هناك هدوء لعدة ساعات.
هذا السلوك ذكرني بما فعلت في شهر آذار حين شاهدت خبراً يتحدث عن عاصفة التنين الرملية التي ستضرب الشرق الأوسط، أول مافكرت به البحث عن اسم سوريا بين تلك الدول التي ستضربها العاصفة وأنا أدعو أن يكون لسوريا نصيب منها، حتى تسكن الطائرات، ويعيش السوريون في الداخل يوماً من الهدوء دون خوف أو قلق من الموت، حتى وإن كانت أياماً عثة يصعب استنشاق الهواء فيها، أو مطراً يسبب سيولاً في المدن فهي أيضاً تحمي من الموت المحتوم القادم من سماء النظام.
منصور حسين