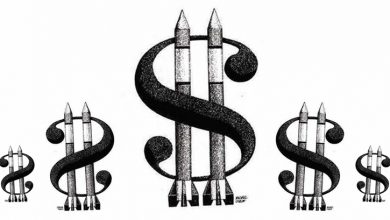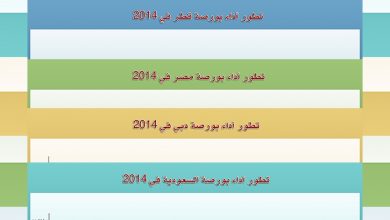تسارعت الأحداث المأساوية هذا العام في سوريا والعراق، وتداخلت الصراعات الداخلية الطاحنة فيهما بأُخرى إقليمية ودوليّة. واستمرّ لبنان من جهته في تأزّمه السياسي وصار استقراره مرتبطاً أكثر فأكثر بمؤدّيات التطوّرات السورية والعراقية ومسالكها.
وليس فقدان المناعة اللبناني تجاه جارَيه القريب والبعيد نتاج هشاشة الإجماعات الوطنية فيه التي شهدنا لها سوابق ابتداءً من العام 1958 فحسب. بل ثمة أيضاً تراكمات ومعادلات أفضت الى الوضع الراهن بترابط صراعاته، يفيد التذكير بثلاثٍ من محطّاتها.
عن المحطّات العراقية
في «السياسة» السورية لبنانياً
المحطّة الأولى هي تلك التي شهدت تأسيس حزب الله أوائل ثمانينات القرن الماضي، بما هو ثمرة تعاون إيراني سوري حاكى بعض المتغيّرات اللبنانية التالية لخروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان ولانطلاق الحرب العراقية على إيران. فتحالف طهران ودمشق منذ العام 1980 وُلد من حاجة الإيرانيين الى حليف عربي يمنع صدّام حسين من استخدام المعطى القومي في حربه معهم، ووُلد أيضاً من بحثهم عن جسر عبور إلى لبنان يُتيح تصدير ثورتهم إلى بيئته الشيعية بتماسها الجغرافي مع إسرائيل واحتلالها. وفي الضفّة المقابلة، كان حافظ الأسد يريد استنزاف خصمه العراقي في الحرب مع إيران والخلاص من أدواره إقليمياً، وكان يريد كذلك التحوّل وسيطاً بين إيران المعزولة والغربيّين والخليجيين، على نحو يمكّنه من امتلاك أوراق مقايضات، ليس أفضل من الساحة اللبنانية وحروبها حيّزاً لها.
المحطّة الثانية هي التي شهدت التفويض الأميركي لحافظ الأسد بالوصاية على لبنان العام 1991، بعد انخراط الجيش السوري في التحالف العسكري الأميركي ضد العراق لطرد قوّاته من الكويت، وبعد قبول دمشق المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام ثم في المفاوضات مع إسرائيل. وقد أدّى الأمر الى إطلاق يد الأسد لبنانيّاً، وتأسيسه مرحلة الهيمنة السورية على القرار السياسي في بيروت وإدارة العلاقة بين أطراف المعادلة اللبنانية، وإشرافه بالتنسيق مع إيران على عمليّات حزب الله العسكرية ضد إسرائيل في الجنوب المحتلّ بما يخدم التفاوض السوري مع تل أبيب ويؤمّن لنظامه قواعد اشتباك لا تكلّفه شيئاً، وتجعله فوق ذلك وسيط وقف إطلاق نار أو ضبط رقع العمليّات العسكرية بطلب أميركي يجدّد له دورياً وصايته اللبنانية.
المحطة الثالثة هي محطّة انتهاء تفويض واشنطن للأسد (الإبن، هذه المرّة) في لبنان العام 2003، نتيجة الاجتياح الأميركي للعراق وإسقاط صدّام حسين وانتفاء الحاجة الى وظيفة الضبط الإقليمي التي كانت تضطلع بها دمشق بعد قرار بوش (الإبن) بتغيير موازين القوى في الشرق الأوسط، وبعد انهيار العملية التفاوضية واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وحصار ياسر عرفات. وقد تَرجم القرار الأممي 1559 الصادر في صيف العام 2004 إنهاء الوصاية المذكورة رسمياً، وهو جاء ترجمةً لمصالحة فرنسية أميركية تلت خلاف باريس وواشنطن حول غزو العراق.
بهذا بدا أن عملية التفويض الأميركي لنظام الأسد بالوصاية على لبنان ثم إنهائها ارتبطت بلحظات عراقية شهدت كلّ مرّة تطوّرات جسام لم تنته كامل آثارها بعدُ. وفي سياقها، جرت عملية إغتيال الرئيس الحريري بعد اتّهامه بالتآمر على سوريا ودورها اللبناني، ثم قامت انتفاضة الاستقلال فتكثّفت الضغوط على نظام دمشق، واضُطر في نيسان العام 2005 الى سحب قوّاته من لبنان بعد 29 عاماً من اجتياحها له.
لكن الخروج العسكري السوري لم يرافقه أو يليه طيّ صفحة أو تأسيس حقبة وِفق عقدٍ سياسي لبناني جديد. ولا انتفى بعد هذا الخروج تأثير الوضع العراقي في تطوّراته المتلاحقة على لبنان. فبين الهجوم المضاد الذي شنّه نظام دمشق بدعمٍ من حزب الله الذي اندفع نحو الداخل اللبناني للتحكّم به وإعادته الى توزيع المهام الذي كان قائماً أيام الأسد الأب، وبين تقدّم الدور الإيراني في المنطقة من البوّابة العراقية التي احتلّ حلفاء طهران أبرز مفاتيح السياسة والأمن فيها (بعد حلّ الأميركيين للدولة وإقرارهم سياسة اجتثاث «البعث»)، تصاعدت التوتّرات في لبنان وتواصلت الاغتيالات والتفجيرات الأمنية واتّخذت الصدامات السياسية أكثر فأكثر بُعداً مذهبياً شيعيّاً سنّياً انتقل أحياناً الى الشارع وفاقمته على نحو خطير سيطرة حزب الله عسكرياً على بيروت في 7 أيار 2008 ثم سيطرته أمنيّاً على العاصمة في كانون الثاني 2011 وإسقاطه الحكومة بالقوة (الخشنة أو الناعمة) في المرّتين.
الثورة السورية وإيران
و«الدولة الإسلامية»
في آذار 2011 اندلعت الثورة السورية، ولم يكن صعباً تخيّل انخراط حزب الله في القتال ضدّها بعد تحوّلها في أيلول من العام نفسه الى كفاح مسلّح فرضته بربريّة قمع المتظاهرين وتعذيبهم واحتلال جيش الأسد ومخابراته للساحات العامة في المدن والبلدات الكبرى والمتوسّطة لمنع التجمّع فيها.
وبالفعل، اشتبكت مجموعات للحزب كانت في الداخل السوري لحماية مواقع أمنية ومستودعات ذخيرة أكثر من مرّة مع عناصر من الجيش الحرّ، وتزايد الحديث عن أدوار لخبراء روس وآخرين في الحرس الثوري الإيراني يساعدهم كوادر من حزب الله في تدريب «الأمنيّين السوريّين»، الى أن أعلن الحزب انخراطه رسميّاً في المعارك في صيف العام 2012 خلال تشييعه عدداً من عناصره الذين سقطوا في محيط دمشق. وقد تلى الأمر إرساله ألوفاً من مقاتليه الى أكثر من جبهة لمعاونة جيش النظام حين بدا أن المعارضة أصبحت في مسار عسكري تصاعدي (بدعم سعودي وقطري وتركي) لم يقتصر على المناطق الطرفية في سوريا بل بدأ يهدّد سيطرة النظام على دمشق وحلب، وبينهما على حمص، عقدة الربط بين الساحل السوري والعاصمة. وتدرّجت مراحل الانخراط العسكري للحزب الشيعي اللبناني الى أن أصبح شديد الشراسة بعد آذار 2013 حين قاد معركة القصير والبلدات المحيطة بها.
ترافق ذلك مع إيفاد طهران للألوف من المقاتلين الشيعة العراقيين (ثم الأفغان الهزارة) الى جبهات دمشق وريفها لمؤازرة قوّات النظام. وترافق ذلك أيضاً مع بدء وصول المئات (ثم الآلاف) من الجهاديّين السنّة الى الشمال والشرق السوريّين عبر الحدود التركية والعراقية وانضمامهم الى «جبهة النصرة» القليلة الوزن آنذك والمكتسبة بفضلهم ثقلاً ودوراً متعاظمَين. كلّ هذا قبل أن يُعلن أبو بكر البغدادي من الموصل في نيسان 2013 تأسيس «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) فيستقطب معظم أجانب «النصرة» ويسيطر تدريجياً على الرقة وريف حلب الشرقي، ثم على أجزاء من دير الزور مقاتلاً المعارضة السورية بفصائلها المختلفة وواضعاً إياها بين نارين: نار عناصره ونار النظام وحلفائه الشيعة. ورافقت تأسيس «داعش» عراقياً هجمات وتفجيرات واغتيالات استهدفت قادة عشائريّين سنّة عملوا في سنوات سابقة ضمن «الصحوات» التي قاتلت تنظيم «القاعدة» بزعامة أبي مصعب الزرقاوي، سلَف البغدادي، ومؤسّس نهجه المبتعد تدريجياً عن نهج القاعدة (ممثّلةً بالظواهري).
وشهد لبنان خلال تلك الفترة، واستمراراً حتى أوائل العام 2014 سلسلة تفجيرات استهدفت المدنيين في أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت، ثم في طرابلس، وشهد أيضاً إشتباكات متنقّلة بين عاصمتي الشمال والجنوب، على نحو أحيا المخاوف من تحوّله من جديد ساحة صراعات إقليمية بأدوات مذهبية داخلية.
لكن الحدث الدراماتيكي الذي طغى على تطوّر الأوضاع السورية واللبنانية والتأثير الإيراني الكبير في مسارها أتى في حزيران 2014 من العراق، حيث انهار جيش حكومة بغداد أمام «داعش» في وسط البلاد كما في شمالها الغربي، وأعلن البغدادي «عودة الخلافة» وقيام الدولة الإسلامية على رقعة شملت مناطق واسعة من العراق وسوريا. وأدّى الأمر الى تغيير الكثير من المقاربات الإقليمية كما الدولية لأشكال التعاطي مع الصراع المشتعل في المنطقة. فقرّر الأميركيون، بعد طول انكفاء وتردّد، التدخّل العسكري الجوّي ضد «داعش»، واضطُرّت إيران للتخلّي عن حليفها العراقي المالكي والإتيان بشخصية أقل استفزازاً للأحزاب والتيارات العربية السنية والكردية في العراق، واصطفّت معظم دول المنطقة في «التحالف الدولي» ضد «داعش»، في حين ظلّت تركيا خارجه مشترطةً ربط ضرب «داعش» بضرب نظام الأسد، أو على الأقلّ بفرض منطقة سوريّة آمنة تحمي المعارضة من طيرانه وقصفه المدفعي. وأيّدتها فرنسا في موقفها، وحصرت مشاركتها في العمليات بالأراضي العراقية.
بموازاة ذلك وربطاً به، تحسّنت العلاقة بين طهران وواشنطن، واستمرّت المفاوضات حول الشأن النووي وحول دور إيران الإقليمي، وغابت بضغط من إدارة أوباما تهديداتُ إسرائيل لإيران وردود الأخيرة عليها، فيما شهد الخليج العربي توتّرات بين عدد من دوله بسبب الأوضاع المصرية والعلاقة بتركيا وأشكال إدارة المواجهة مع إيران في العراق وسوريا.
ويمكن القول هنا إن مسألةً في غاية الأهمية ظهرت في العامين الأخيرين، هي مسألة امّحاء الحدود ولَو مؤقّتاً بين العراق وسوريا ولبنان. فالهيمنة الإيرانية على البلدان الثلاثة إذ تعرّضت للتهديد في حلقتها السورية الوسيطة، تحوّلت الى فتح الحدود على نحو أدّى الى تنقّل الألوف من المسلّحين وعشرات الألوف من أطنان الأسلحة والعتاد نحو سوريا ذهاباً، ثم في حالات محدّدة – بعد تقدّم «داعش» في نينوى والموصل وصلاح الدين – إياباً نحو العراق. ولا يمكن أصلاً فهم صعود «داعش» دون الوقوف على ما سبّبته الهيمنة الإيرانية في العراق (والمنطقة) من ضيق سنّي ومن جاذبية استقطابٍ لكل جهة مستعدّة لمواجهة الأمر الواقع الجديد، بالإضافة طبعاً الى ما خلّفه تفاقم الأوضاع في سوريا واستقالة «المجتمع الدولي» من مسؤوليّاته تجاهها من فوضى وفراغ ملأته «داعش» في أكثر من منطقة. وساعدتها في مهامها العراقية والسورية موارد مالية وفّرتها شبكات إسلامية وتجارة نفط وتحصيل ضرائب من المواطنين الواقعين تحت سيطرتها ومن التجار في تبادلاتهم وتنقّل بضائعهم نحو دول الجوار (تركيا والأردن).
والصعود الداعشي هذا أدّى بدوره الى تكريس امّحاء الحدود العراقية السورية من خلال إعلان دولة الخلافة على مساحة تشكّل حدود البلدين الموجودة ضمنها مجرّد ممرّ. وصرنا بالتالي أمام مشهد «شرق أوسطي» جديد، تعبر فيه «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» حدود ثلاث دول للدفاع عن سطوتها الإقليمية (وتملك في دولة رابعة، هي اليمن، حليفاً يتقدّم في وجه خصومه المحلّيين). وتقوم بمحاذاتها وبمواجهتها، ولو بإمكانيات وعلاقات أقلّ بكثير، «دولة الخلافة الإسلامية» العابرة حدود دولتين والمهدّدة حدود دولتين أُخريين، لبنان والأردن، في حين تعجز حتى اللحظة دول الجوار العربي ومعها تركيا – عن حسم الأمور أو التأثير السريع في اتجّاهات سيرها.
لبنان حيث الدولة شبح
وسط هذا التطاحن الإقليمي واحتمالاته المفتوحة على المزيد من الأهوال، يبدو لبنان مُقبلاً في ظلّ انقساماته وانخراط أحد مكوّناته بالحرب السورية (وفق أعذار وتبريرات بدأت بحماية شيعة لبنانيّين مقيمين في وادي العاصي، ومرّت بالحفاظ على المقدّسات الشيعية في السيدة زينب، ثم بالتصدّي للمؤامرة الإمبريالية-الصهيونية، قبل أن ترسو على ادّعاء قتال «داعش» والجهاديّين استباقياً خلف الحدود)، يبدو لبنان مقبلاً على مرحلة تصدّع جديدة. فعلى طول خط السلسلة الشرقية من البقاع الى الشمال، تهدّد مجموعات سورية تختلف ولاءاتُها حزبَ الله بالردّ داخل الأراضي اللبنانية على احتلاله لبلدات ومناطق سورية. وفي مواجهة ذلك، يستمرّ الحزب الشيعي باستعراض قوّته وتجاهل الدعوات الى انسحابه من مأزقه السوري، ويستمرّ الجيش اللبناني من جهته في ارتباكه الميداني نظراً لقدراته العسكرية واللوجستية المحدودة وللانقسام السياسي الحاد في البلاد الذي يزيد مهمّته صعوبة.
يُضاف الى ذلك أن لبنان يُعاني منذ سنوات من مشكلة بنيوية في نظامه السياسي بلغت ذروتها هذا العام، مع تعذّر انتخاب رئيس جمهورية ومع تمديد المجلس النيابي لنفسه لعجزه عن اعتماد قانون انتخاب جديد، ومع أزمات حكومية متكرّرة. والفلسفة التوافقية التي يعتمدها البلد منذ دستور العام 1926 وتفاهمات الميثاق الوطني العام 1943 ثم تعديلات اتفاق الطائف العام 1989 تعرّضت لنكسات كبرى عشيّة الحرب الأهلية ثم خلالها وطيلة مرحلة الهيمنة السورية وصولاً الى يومنا هذا.
فالتوافقية تتطلّب مرونة في الممارسة السياسية وقبولاً دائماً بتسوويّة كانت الحرب إيذاناً بصعوبة الاستمرار بها. كما أن النخب السياسية اللبنانية انتقلت خلال العقود الماضية من طور الاقطاعات المحدودة القدرة الاستقطابية الى «إقطاعات» قادرة على الاستقطاب الواسع وعلى احتكار التمثيل ضمن طوائفها لمواجهة بعضها. ويستتبع بالتالي كل صدام بينها أو كل انسحاب لواحدها من المؤسسات تعطيلاً للأخيرة وشللاً للنظام بأكمله.
والتوافقية إذ صُمّمت في لبنان وفق مبدأ قسمة سُلطة مسيحية مسلمة تحوّلت منذ سنوات الى التعامل مع قسمة سنّية شيعيّة ينقسم المسيحيون (المُتراجعون ديموغرافياً) تجاهها بعد أن فقدوا دورهم القيادي خلال الحرب ثم خلال الحقبة السورية. وهذا يعني أن موقع رئاسة الجمهورية المركزي في الصيغة التوافقية الذي عُقد لهم صار موضع تجاذب سنّي شيعي لا يستطيعون فعل الكثير حياله. وليس أكثر دلالة على تراجع دورهم ضمن المعادلة الطائفية الرئاسية وضمن النظام التوافقي نفسه من اضطرارهم للقبول بتعديل الدستور دورياً منذ العام 1995 عند كل استحقاق رئاسي (تمديداً لرئيس أو سماحاً لقائد جيش بالترشّح). كلّ ذلك مع أمرٍ واقع أشدّ وطأة على التوافقية، هو ملكيّة ممثّل طائفة لبنانية، حزب الله، لفائض قوة تجسّده ترسانة أسلحته وحصرية امتلاكه لقرارات الحرب والسلم بالنيابة عن البلد بأكمله، وغالباً على عكس إرادة قسم كبير من مواطنيه. وهذا يمكّنه من قتال إسرائيل (دفاعاً عن لبنان أو عن إيران) من دون الرجوع الى أحد، ويمكّنه أيضاً من عبور الحدود اللبنانية السورية لقتال المعارضة دفاعاً عن نظام الأسد. ويمكّنه كذلك من إرسال مدرّبين عسكريّين الى العراق لدعم قوى مذهبية في وجه قوى أُخرى، من دون استشارة شركائه في السُلطة في بيروت رغم احتمالات تحمّلهم وإياه انعكاسات سياساته وردود خصومه عليها.
ولا يبدو أن تصدّع التوافقية اللبنانية في طريقه الى الرأب أو حتى الى حصر الأضرار. ولا يبدو كذلك أن ثمة قدرة على الاستغناء عن التوافقية المأزومة إياها أو تخطّيها. ممّا يعني أن احتمالات المراوحة وسط الشغور الرئاسي ومفاعيل التمديد النيابي والعجز الحكومي مفتوحة، وأن لبنان دولة يصحّ تسميتها بـ»الدولة الشبحية» إذ لا يظهر فعلياً في أيٍّ من مناصبها الرسمية من يحكمها ويُديرها. وربما ما يقيها من التشظّي حتى الآن هو تقديم اللاعبين الإقليميّين والدوليّين للساحتين العراقية والسورية كساحتَي صراعٍ عليها من جهة، وقدرة مجتمعها نتيجة خبرته الطويلة في تسيير بعض شؤونه وتدبّر اقتصاده من جهة ثانية.
على سبيل الخلاصة
لبنان والمشرق بأسره يدخلان إذاً مرحلةً غامضة المآلات. قد يكون العنف المعمّم أكثر ما في معالمها وضوحاً الآن، ولا يضاهيه في الوضوح هذا سوى التهجير والتبدّلات الديموغرافية التي – وإن كانت ظرفية – إلا أنها لن تنتهي من دون آثار وأضرار. فأن يتهجّر داخلياً أكثر من ثلاثة ملايين عراقيّ مقلّصين بانتقالهم القسري من منطقة الى أُخرى رقعة «التعايش» المذهبي والقومي في العراق، وأن يتهجّر داخلياً أو ينزح نحو الخارج قرابة العشرة ملايين سوري، أي أكثر من أربعين في المئة من سكان سوريا، وأن يُصبح ثلث القاطنين في لبنان تقريباً من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين يعيش جلّهم في ظروف صعبة، وأن يتحوّل «مخيم الزعتري» في الأردن الى واحد من أكبر «المدن» في المملكة (قد يصبح قريباً المدينة الثانية بعد العاصمة عمّان)، فالأمر فيه من التمزّق السياسي والاجتماعي-السياسي في المنطقة الكثير.
لا يعني هذا بالضرورة أننا أمام نهاية مشرقِ ما بعد السلطنة العثمانية و»سايكس بيكو». ولا يعني كذلك أن ثمة إرادات دولية تريد التقسيم أو إعادة تشكيل الخرائط، وليس لهكذا إرادات القدرة أصلاً على فرض كلّ ما تريد في المرحلة الراهنة وما فيها من فاعلين وأحلافٍ وتناقضات. لكن المنطقة هي اليوم، في آخر العام 2014، أمام لحظة تأسيسية جديدة، تماماً كما كانت حقبة 1915 1920. قد تؤدّي اللحظة هذه الى تبدّلات كبرى، وقد تبقى تعديلاتها في المقابل داخل كل بلد بعد إعادة تشكيل السلطات فيه وتعديل موازين قواها. وهي في أي حال، وبمعزل عن نتائجها، لن تُرسم هذه المرّة في لندن وباريس، ولا في واشنطن وموسكو. ستُرسم على الأرجح في المدن المذكورة مجتمعة كما في طهران والرياض وأنقرة والدوحة وبغداد ودمشق وبيروت وعمّان والقدس. وستُرسم أيضاً في جبهات القتال ومخيّمات اللاجئين. أي أنها إن لم تحمل في مآلاتها حدّاً أدنى من العدالة وضمانات الاستقرار، فلا شيء سيحول دون انفجارها من جديد ودون إعادة طرحها لمسائل عاشت المنطقة على تأجيلها منذ زمن بعيد.
نوافذ – وطن اف ام