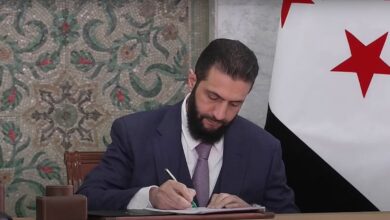يعيش السوريون لحظة قراراتٍ حاسمة في تاريخ ثورتهم المريرة والقاسية، بعد ما حصل في الأشهر الماضية من تطوراتٍ في مواقف الدول، وتحول في موازين القوى العسكرية والدبلوماسية، فقد نجح الروس وحلفاؤهم الإيرانيون، بسبب تخبط الغربيين وضعف إرادتهم، في قلب الطاولة على حلفاء المعارضة، الترك والعرب والأوروبيين، وزاد اعتقادهم بأنه أصبح في إمكانهم، بعد إمساكهم بخيوط اللعبة الداخلية والإقليمية، إقناع المعارضة بأن تسلم بخسارتها الحرب، وتقبل تسويةً تضمن استمرار الأسد في الحكم، وبالتالي تبرئته من خطاياه وجرائمه، وربما تثبيت حقه في ترشيح نفسه بعد المرحلة الانتقالية، والمشاركة في حكومة وحدة وطنية، وتدافع عن وجهة نظرها في التغيير من خلالها. وللتوصل إلى هذا الهدف، تسعى إلى جذب أصدقاء المعارضة إلى صفها ودفعها إلى الضغط على “المتشدّدين” منها، للقبول بالدخول في الصفقة المنتظرة أو الخروج من “اللعبة”. وهذا هو الوضع الذي يكمن وراء الدعوة إلى مؤتمر الرياض2، ورفع شعار توحيد المعارضة من جديد، وجمع المنصات العديدة في وفد موحد، يغلب عليه القابلون بالحل.
أمام هذا “الديكتات”، أو الإملاء الدولي الوحيد، كان من الطبيعي أن تنقسم المعارضة بين فريقين، الفريق الذي يعتقد بأنه لا يوجد خيار آخر أمام المعارضة سوى الإذعان والقبول بمفاوضات أستانة وموسكو والاستمرار فيها، لانتزاع ما يمكن انتزاعه من حقوق الشعب، بالتعاون مع الدول الصديقة، وكسب ود موسكو بشكل أكبر، وأولئك الذين يرون في هذه المفاوضات، ومعها مؤتمر الرياض 2 الذي ينتظر منه تكريس ما يساهم في تحقيق الصفقة الروسية الدولية، عملية انتحار، وينادون بوقف مهزلة المفاوضات في أستانة أو جنيف، واتخاذ موقف نهائي منها.
(1)
أعتقد، بداية، أن وقف النار الذي تعد به مفاوضات أستانة لم يعد اختيارا بالنسبة للفصائل المسلحة، ولكنه أصبح أمرا واقعا وجزءا من استراتيجية الخروج من الحرب، ولا أعني من الثورة، مع الأمل بإنقاذ أرواح مقاتلي المعارضة من جهة، والتخفيف من المعاناة المرّة التي يعيشها السوريون القاطنون في مناطق المعارضة الذين لا يزالون يتعرّضون للموت اليومي بمختلف أشكاله، تحت القصف ومن الجوع والمرض واليأس، من جهة ثانية، ولوضع حد لتدهور العلاقة بين الفصائل المقاتلة وحاضنتها الاجتماعية التي تكاد تصل إلى درجة الثورة عليها لما تراه فيها من خذلانٍ لها، وابتعاد عن روح الثورة، ومن فساد، من جهة ثالثة، وللحفاظ، من جهة رابعة، على الحد الأدنى من الدعم المادي والسياسي الذي تقدمه الدول الصديقة للثورة سابقا، والتي أصبحت اليوم جزءا من مجموعة “الدول المتفهمة أو المتفاهمة”، والتي أصبحت تراهن جميعا على روسيا التي ربحت الجولة الأولى من الحرب الشرق أوسطية الطويلة ضد الولايات المتحدة والغرب، لإيجاد مخرج من الأزمة السورية المستعصية.
ثم إن هذه الفصائل غير قادرة في وضعها الراهن وطبيعة العلاقات التي تربطها بداعميها والثقافة التي تلقاها أفرادها ومقاتلوها خلال السنوات الماضية قادرة على أن تعيد هيكلة نفسها بشكل جدي وفعال، بما يسمح لها بالحفاظ على مواقعها حدّا أدنى، فما بالك بإمكانية تبني استراتيجية جديدة لقلب ميزان القوى من جديد لصالح الثورة، ما يعني أن الحديث عن خيار عسكري للمعارضة أصبح، إلى حد كبير، عديم المعنى، ويهدد بأن يختلط أكثر فأكثر بخيار القوى المتطرفة من منظمات جبهة النصرة وغيرها من المنظمات الإسلامية الجهادية، التي تواجه هي نفسها اليوم وضعا سياسيا صعب الاحتمال.
لكنني، في المقابل، لا أعتقد أن على المعارضة أن تقدم لروسيا، أو لغيرها، ثمنا سياسيا لخفض التصعيد، أو حتى لوقف إطلاق النار. ولا ينبغي أن يعتقد التحالف الروسي أن القبول بوقف القتال، أو حتى إنقاذ أرواح مقاتلي المعارضة يستدعي تقديم تنازلاتٍ سياسية، في ما يتعلق بقضية الثورة والشعب، وهي قضية مختلفة كليا، كما قلت في مقال سابق، عن مسألة الحرب التي اعلنها النظام ضد الثورة، والتي دخلت فيها المعارضة، فوقف القتال مصلحة مشتركة للمتحاربين، ولا يغير، أو لا ينبغي أن يغير، من طبيعة المشكلة، ولا من مضمون الحل، فقضية المعارضة وشرعيتها تختلف عن قضية الثورة وشرعيتها أيضا.
لا شك أن فشل المعارضة في حسم المعركة العسكرية أضعف قوى الثورة، لكنه لم يضعف شرعيتها. بالعكس، ما قام به النظام، ومن بعده طهران وروسيا، هدم كل ما تبقى من شرعية النظام القائم، وكشف عن هويته الحقيقية، وهوية رموزه وولاءاتهم وانتماءاتهم ومطامحهم، كما لم يظهر في أي وقت في السابق. لقد بين سلوك النظام تجاه حركة الاحتجاج الشعبية السلمية أنه ليس نظاما سياسيا، وإنما هو تحالف من القتلة والجانحين، وليس دولة تلتزم بدستور، ولها مؤسسات مستقلة، تخضع في سلوكها لقانون وقواعد ثابتة، وإنما عصابة تلف حولها مجموعة من المصالح الأنانية والانتهازية، وهي على استعداد لقتل الشعب كله، وتوزيع البلاد جوائز للدول التي تقبل مشاركتها القتل والدمار للحفاظ على سيطرتها. التهافت السياسي والعسكري لنظام العصابة، بسبب صمود الشعب والمعارضة المسلحة الطويل عزّز إيمان السوريين بأهداف الثورة وحتمية سقوط نظام القتل والإبادة الجماعية. ولن يغير هذه الحقيقة فشل المعارضة أو التلاعب بها أو تقويض صدقيتها، لإجبارها على الاستسلام، أو التسليم بمشاريع التصفية الدولية.
والواقع أن المشكلة لا تكمن في المفاوضات، وإنما في معرفة ما إذا كانت المعارضة لا تزال تتمسك بأهدافها الأولى، أم أنها تقبل بالتراجع عنها، أو عن بعضها للقبول بتسوية الأمر الواقع، أي باختصار المطلوب هو الجواب على سؤال: هل ينبغي الاستمرار في الثورة، حتى تحقيق الأهداف التي عبر عنها الشعب، عندما زجّ نفسه في الصراع ضد نظام القتلة، أم ينبغي الاتعاظ من الفشل السابق والقبول بتسوية، تنقذ ما يمكن إنقاذه، وكفى المؤمنين القتال؟
لا أعتقد أن أمام السوريين خيارا آخر، إذا لم يريدوا العودة إلى نظام الانتقام الممنهج، والقتل الأعمى، وتعميم منطق العبودية، وتحويل سورية إلى مرتع للصوصية والمحسوبية والفساد غير طريق المقاومة المستمرة، حتى تحقيق أهداف الشعب المحقة والعادلة. ولن تربح المعارضة شيئا من التخلي عن أهداف الثورة. بالعكس، سوف يحولها التراجع عنها إلى معارضة مرتزقة وباحثة عن مناصب، وتفتقر لأي قضية. ما يجعل للمعارضة قيمة ورصيدا، ويجعل الدول الصديقة والعدوة تتواصل معها ليس إنجازاتها وحسن أدائها، وإنما تمثيلها، الوهمي أو الفعلي لا فرق، لقضية الشعب وتمسك بعضها بحقوقه بالفعل. إذا تخلت عن هذه القضية لن تستحق أي منصب، في نظر النظام المعاد تأهيله، وستخسر كل صدقيتها في نظر الشعب، بل وتتحول بالفعل إلى مجموعة من الخونة الذين باعوا دماء الشهداء، للوصول إلى السلطة، ولن يختلف تقييم الناس لهم عن تقييمهم أولئك الموجودين اليوم في السلطة، والذين شنوا الحرب على الشعب، ودمروا وطنه.
هذا مع العلم أن الأسد لم ينتصر، وإنما تحطم عسكريا وسياسيا وأخلاقيا، وتفكك نظامه، واندرج ضمن نظام الانتداب الروسي، وأن حلفاءه من الروس والإيرانيين وقعوا في مستنقع الحفاظ على نظام قاتل ضد شعب حر، ولا ينبغي السماح لهم بالخروج من ورطتهم، وإنما انتظار هزيمتهم، كما حصل لهم، ولغيرهم من المستعمرين المناهضين لإرادة الشعوب من قبل، وأن الشعب السوري دفع الحساب القاسي عمليا، ولم يعد لديه ما يخسره سوى قيوده وكوابيسه وانقساماته وعبوديته.
(2)
في هذه الحالة، لا ينبغي أن يكون السؤال: نشارك أم لا نشارك في المفاوضات الجارية، بصرف النظر عن عقمها، ولكن: نستمر في المقاومة، حتى تحقيق أهداف الشعب، أم نقبل بتغيير أهدافنا ومراجعتها. وإذا كان الجواب بنعم، فأي استراتيجية ينبغي اتباعها لتجاوز النكسات الماضية، وإعادة ترتيب أوراقنا، آخذين في الحسبان تغير ميزان القوى، وتحولات القضية السياسية والدبلوماسية.
في نظري، يحتاج بناء هذه المقاومة والاستمرار في تعقب النظام لإسقاطه واستبداله بنظام يمثل الشعب إلى تحقيق ثلاثة شروط أساسية:
أولا، تغيير أسلوب التفاوض لا الانسحاب من المفاوضات.ثانيا، بناء حركة مقاومة فدائية سورية تعمل من تحت الأرض، وتضم جميع العناصر الحية والنشيطة التي حرّرها خروج الفصائل من المواجهة العسكرية الماضية. ثالثا، بناء الجبهة السياسية، وتفعيل العلاقات الدولية، وتنظيم صفوف السوريين في الداخل والخارج، وتعبئتهم لإعادة إطلاق الحياة السياسية، وخوض معارك تأكيد الوجود والاستمرار في الدفاع عن كرامة السوريين وحرياتهم، عبر التظاهرات وأشكال التعبير السلمي الاخرى.
لا ينبغي للمعارضة أن تنسحب من المفاوضات، أو حتى أن تتردد في خوضها، بل بالعكس عليها أن تطالب بها، وتلح في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من خلالها، لكن ما هو مطلوب منها أن تخوضها بروح أخرى، وإرادة وعزيمة أقوى، وأن تشارك فيها من منطلق ملاحقة المجرم، والدفاع عن حقوق، لا من منطلق الخائف من الخسارة، أو المتشكك في طلب الحق، أو المستعد للمساومة عليه.
فالمعارضة ليست في موقف الضعف، بل القوة، فهي تتحدث باسم شعب صمد ست سنوات في وجه تحالفٍ عدواني، لا يتردد في تبني خيار الإبادة الجماعية، واستخدام أسلحة الدمار الشامل، لتحطيم القاعدة الشعبية، لا لضرب المقاتلين فحسب. وهي تتمتع برصيدٍ لا يضاهى، هو قضية الدفاع عن الكرامة والحرية العادلة لشعبٍ انكوى بنار القهر والفاشية، وما يقارب المليون شهيد وملايين الضحايا المشرّدين واللاجئين والمنكوبين، وهي تقف في مواجهة نظامٍ، رصيده الوحيد استخدام كل أنواع الأسلحة لتعظيم وتيرة القتل، والغدر بشعبٍ تحكم في مصيره منذ نصف قرن، وخيانة جميع العهود والمواثيق، الوطنية والدولية، الإنسانية والسياسية، وتدمير بلده والتفريط بسيادته واستقلال وطنه، وفتح الأبواب واسعة أمام الاحتلالات والانتدابات الاجنبية، لهدف وحيد واحد، هو الحفاظ على سلطته الشخصية الاستبدادية والفاسدة.
في هذه الحالة، سيصبح للذهاب إلى المفاوضات معنى وجدوى، بل ستصبح المشاركة فيها واجبا وجزءا من المعركة السياسية والدبلوماسية. ولن تذهب المعارضة إلى تقديم التنازلات وتغيير الأهداف، ولكن للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإعادة اللاجئين، وإنهاء الاحتلالات الأجنبية، وإلزام المجتمع الدولي باحترام حقوق السوريين، ورفع الظلم عنهم، وتمكينهم من تقرير مصيرهم بحرية، بعيدا عن الإملاءات والتدخلات الأجنبية. ولا ينبغي للمعارضة أن تمل أو تكل من تأكيد شرعية هذه الحقوق، حتى لو استمرت المفاوضات سنواتٍ أخرى، ووقف في وجهها العالم كله. وهي حقوق واضحة كالشمس: التخلص من كابوس الاحتلال الداخلي والخارجي، وحكم القهر والقوة.
لكن حتى مع النجاح في تكوين مثل هذا الوفد المتمتع بثقة السوريين وتأييدهم، لن يكون للمفاوضات قيمة، أو مقدرة على التوصل إلى تسوية مقبولة مع الدول المحتلة والمنتدبة، من دون وجود ذراع عسكري يضغط من تحت، ويبقي جمرة الكفاح المسلح مشتعلة وقابلة للاشتعال أكثر.
(3)
وهذا ينقلنا إلى الميدان العسكري. فلا ينهي التوقيع على اتفاقات خفض التصعيد، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح المقاتلين والأهالي الخاضعين لعمليات القصف والانتقام، أو لا ينبغي على المعارضة أن تعتقد أنه ينهي مهامها العسكرية، فالتمسك بأهداف الثورة والشعب التي أصبحت أكثر شرعية وضرورة، بعد بروز عنف النظام وإجرامه، يحتاج إلى رفد الصراع السياسي بذراع ضاربة عسكرية، لا تستقيم المفاوضات السياسية من دونها، طالما استمر النظام في استخدام آلتها العسكرية وآلة حلفائه للي ذراع المعارضة، إن لم يكن لكسرها. وهذا لا يتحقق بالتوقف عن القتال، وتسريح مقاتلي المعارضة، أو إلحاقهم بالحشود الدولية لقتال “داعش”، أو بتحويلهم إلى العمل في فصائل تخدم أذرعا للدول الصديقة، أو شبه الصديقة. المطلوب بالعكس إعادة تأهيل القسم الأنشط منهم، وإعدادهم للقيام بمهام المقاومة، وقبل ذلك تربيتهم وتدريبهم، ليكونوا في خدمة قضية الشعب، ومستعدين للتضحية بأنفسهم من أجله، أي ليصبحوا حركة مقاومة فدائية سورية وطنية، طويلة المدى، هدفها وبرنامج عملها الحفاظ على أهداف الثورة، والرد على تطلعات الشعب، وضمان وصوله إلى استعادة حقوقه المهدورة واعادة بناء الدولة والمؤسسات.
وأخيرا، إلى جانب تغيير أسلوب التفاوض، وإعادة بناء قوى المعارضة المسلحة، وتغيير استراتيجيتها، هناك النشاط الأكبر والأهم الذي يشمل العمل مع جميع فئات الشعب السوري، ومع الرأي العام الدولي، لاستعادة الأرض التي خسرتها المعارضة لأسباب ذاتية وموضوعية معا، فالمفاوضات ستبقى عقيمة، من دون عصا المقاومة الميدانية، والذراع العسكرية وسيلة مهمة للضغط على الخصوم، وربما الأصدقاء، لكنها لا قيمة لها أيضا من دون أن تكون جزءا من منظومة علاقات دولية وسياسية وإعلامية واجتماعية. وهذا ما قصدته في الحديث عن إعادة بناء الجبهة السياسية الداخلية واستعادة الصدقية والثقة العالمية بعد سنوات من الخلط المتعمد بين أهداف الثورة السورية التحرّرية، ودعوات منظمات التطرف والإرهاب المذهبي والديني، الإرهابية وغير الإرهابية.
ومنذ الآن، بدأ السوريون، الذين سئموا وعود الدول ومفاوضات تمرير الوقت، ويئسوا من قدرة منظمات المعارضة القديمة/الجديدة على مواجهة مهام التحرّر السوري وتحدياته، يطلقون مبادرات بناءة في الداخل والمهجر، في كل الاتجاهات، السياسية والقانونية والإنسانية والإدارية، ولن يمر وقت طويل، قبل أن يستعيدوا أنفاسهم، ويستخدموا الخبرة الكبيرة التي راكموها خلال صراعهم المرير من أجل التحرّر من ذل العبودية، لتنظيم أنفسهم، وتشكيل مجالس وقيادات محلية، أو مؤسسات تحل محل الدولة المختطفة، وتقوم بالمهام التي فشلت في القيام بها، أو يعملون على تكوين شبكات دعم ومساندة للثورة في الخارج، ولجان تواصل واتصال للعمل مع الحكومات والقوى الأجنبية، وتحفيزها لمساندة القضية السورية، وعدم التسليم لمنطق القوة الغاشمة الذي يهدّد بزعزعة العلاقات الإقليمية والدولية.
بعد هذا الحجم الهائل من التضحيات، لا يمكن لأي شعب حر أن يسلم أو يستسلم، ولا للرأي العام أو المعارضة أن يخدعا بأكاذيب المجتمع الدولي، والدول الصديقة والعدوة وألاعيبها وكلامها المعسول. في النهاية، تسعى كل دولة إلى تعظيم مصالحها، ونادرا ما تضحي من أجل المبادئ، وبالأحرى من أجل مصالح دولة أخرى. وفي منطقتنا، حيث الدولة في معظم الأحيان ملكية خاصة، لطغمة أو أسرة أو عائلة شبه إقطاعية، ليس هناك أي مانع لدى الحكومات من الانقلاب على حلفائها، والتضحية بأقربهم منها، إذا بدا ذلك ضروريا للحفاظ على النظام.
المصدر : العربي الجديد