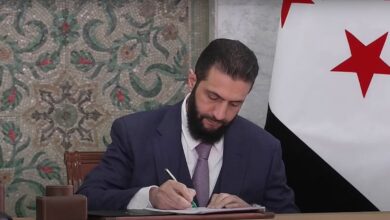في اليوم الرابع من شهر يونيو/ حزيران عام 1967، وجه أحد شعراء “البعث” رسالة إذاعية مفتوحة إلى الأمة العربية، تدعوها إلى الاصطياف في نهاريا، مدينته الفلسطينية التي سيحرّرها جيش “البعث” في الساعات الأولى لنشوب حرب التحرير والعودة، القادمة بإرادة الله، التي لا رادّ لها. بعد أربعة أيام من الدعوة إلى الاصطياف في فلسطين المحرّرة، كانت رئيسة الاتحاد النسائي في حينه تطلق صرخات استغاثة يائسة من إذاعة النظام تناشد العالم أن يسارع فورا إلى وقف تدمير دمشق، أقدم مدينة في العالم، على يد العدو الصهيوني، الذي ادّعت كذبا أنه يشن عليها موجات قصفٍ متلاحقةٍ أسقطت عشرات آلاف الشهداء من أطفالها ونسائها. في ذلك اليوم، أي بعد أربعة أيام من الاصطياف في نهاريا، أذاع وزير دفاع النظام، الفريق الركن حافظ الأسد، بيانا أعلن فيه سقوط القنيطرة، عاصمة الجولان، في يد العدو، وأمر جيشه في رسالةٍ إذاعية موجزة، وليس بالطرق العسكرية، السرية عادة، بتنفيذ انسحابٍ كيفي مما صارت تعرف فيما بعد باسم غامض هو “الهضبة”، وكم بوغت العدو بالخبر المفخّخ الذي أسقط القنيطرة في يده، على الرغم من أنه لم يكن قد وصل إليها بعد، بل كان على مسافة ثلاثة أيام منها.
في وقتٍ لاحق، قال رجال قانون سوريون إن أمر وزير الدفاع الفريق حافظ الأسد بالانسحاب الكيفي يعادل قانونياً حل الجيش الذي تسابقت وحداته العقائدية إلى تنفيذ أمر “المعلم”، فتخلت عن سلاحها وذخائرها، وعن أرض كان ضباطه وجنوده يعلمون أنها لم تسقط، لأنهم كانوا فيها لحظة إذاعة الخبر، لكنهم سلموها من دون قتال إلى عدوٍّ ظن أول الأمر أن “الأسد” نصب لهم فخّا محكماً، ثم أيقن قادته أن نية الوزير الذي يحمل اسم “البهيم الأشرس” طيبة، وأن النتيجة الوحيدة التي أملت عليه أمره كانت دبّ الفوضى في صفوف جيشه العقائدي، وتفكيكه، وإجباره على تنفيذ انسحاب فوضوي من أرضٍ لا يهدّده أحد فيها أو منها، مليئة بالتحصينات والأسلحة والذخائر والمؤن. بعد ثلاثة أيام من الحيرة والارتباك، أذعن العدو للأمر الأسدي، ونشر جنده في الجولان، ولبي دعوته إلى احتلال القنيطرة.
بين وعد التحرير والدعوة إلى الاصطياف في نهاريا، وحرب لم تدم غير سويعات قليلة، سلم الأسد الجولان لإسرائيل وحل الجيش، ولم يقم بأي إجراء لحماية سلاحه الجوي من التدمير، وتركه مصفوفا بانتظام على مدارج مطاراته، ووهب إسرائيل آلاف الدبابات والمصفحات والمدافع الأرضية والمضادة للطائرات بذخائرها، عرفانا بتفاعلها الإيجابي والمتفهم معه.
بعد هزيمته التي قال خبراء عسكريون سوفييت وأوروبيون إنها كانت إذاعية أكثر منها عسكرية، بشر النظام الشعب: أن “الحزب القائد” وجيشه الهارب من القتال أحبطا مؤمراة إمبريالية/ صهيونية، استهدفت “نظامه الوطني/ التقدمي، ومنعا العدو من إسقاطه، وحققا انتصارا سياسيا تاريخيا عزّ نظيره في معارك الشعوب والدول وحروبهما، قديمها وحديثها. وكان الأسد يدّعي، في بلاغاته الحربية، حتى قبل دقائق من إذاعة أمر تسليم الجولان في التاسعة من صباح يوم 9 يونيو/ حزيران أنه يدمر الكيان الصهيوني، وأنه لم يبق على إزالته من الوجود غير أيام معدوداتٍ على أبعد تقدير. وحين أقر بأنه كان يكذب، أطلق كذبة جديدة، هي أنه أحبط مؤامرةً على النظام، وأن ضياع الأرض الوطنية ليس مهما، بما أن النظام الثوري يستطيع تحريرها متى أراد، بالقوة طبعا، أما إذا سقط النظام، والعياذ بالله، فستكون الإمبريالية والصهيونية قد حققت نصرا استراتيجيا لا مثيل لنتائجه الكارثية على عموم الرب والإنسانية التقدمية جمعاء. أفشل الأسد المؤامرة. لذلك، يجب توجيه شكر شعبي/ وطني خاص له، لإحباطه مخططا جهنميا، بمجرد إذاعة بيان يبدو، في الظاهر، أنه تخلى عن الجولان، بينما أنقذ في الحقيقة والواقع نظاما ثوريا استهدفه الصهاينة، لكنه خيب آمالهم بعبقرية ردّه الذي وضعهم أمام معضلتين: نجاة النظام الثوري، واستحالة الاحتفاظ بالجولان. وقد تساءل النظام بألف لسان: أليس إفشال المؤامرة شرط تحرير الأرض، في إطار استراتيجيةٍ ثوريةٍ، وضعت أصلا لتحرير فلسطين وتحقيق “الوحدة والحرية والاشتراكية”، في سورية والبلدان العربية.
ذات يوم، احتلت فرنسا أرضا ألمانية، فجمع رئيس أركان جيشها مساعديه، وأمرهم بوضع خطة لتحريرها، وهو يقول: “سنفكر فيها ونعمل لتحريرها دوما، لكننا لن نتحدث عنها أبدا”. بعد احتلال الجولان، وانقلابه العسكري عام 1970، اعتمد حافظ الأسد استراتيجية “سنتحدث عنه دائما، لن نفكر فيه أو نعمل لتحريره أبداً”. وبفضل هذه الاستراتيجية التي حافظت على النظام منذ 1967، يرزح الجولان تحت الاحتلال منذ خمسين عاما، بلور الأسد خلالها سياسةً حولت احتلاله إلى “لاـ قضية”، استهلكتها مزايداتٌ ضد جميع الأطراف الداخلية والعربية، هدفها وحدة شعب سورية، وكتم أنفاسه، وتشويه مشاعره الوطنية، وتخويفه من عقابيل أي ذكرٍ للجولان، وردع معارضيه وتخوينهم واتهامهم بالعمالة للعدو، بذريعة أن أنشطتهم تمنعه من تحرير فلسطين والجولان، بما تحدثه من انقسام وطني، وبما تضعه من عراقيل تضعف فرص إجهاز “الثورة” على عملاء الصهاينة في البلدان العربية، وخصوصا الذين منهم في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وقياداتها، وقوى لبنان الوطنية، ونظام العراق وجميع من رفضوا “المساعدة الأخوية” التي قدمها جيشه للبنان بغزوه واحتلاله عام 1976، لرد مؤامرة السلام الصهيونية التي أيقن الأسد بوجودها خلال محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي، هنري كيسنجر، عام 1974، الذي طالبه باحتلال القطر الشقيق، وتكفل بالحصول على ضوء أخضر شخصي من رئيس وزراء العدو، المجرم مناحيم بيغن الذي لم يكتف بمنح موافقته، وإنما ادّعى أنه يؤيد خطتنا لإحباط التسوية بين كيانه وأنور السادات، ولمنع فرضها على البلدان العربية الأخرى، وخصوصا لبنان، خاصرة نظامنا المقاوم الرخوة، الذي التزم بيغن، في تصريح علني، بحماية أقلياته وطوائفه، تكريسا لسلام أمر واقع، يفضله على السلام التعاقدي مع مصر. وأكد رئيس أركان جيش العدو أننا تقيدنا بعدد من تم الاتفاق مع كيسنجر على إرسالهم من جيشنا إلى لبنان، وأشاد بدورنا في تأجيج سعير الحرب الإيرانية/ العراقية، واعتبره دليلا على رغبتنا في انتهاج سياساتٍ تطوي، بعد فصل القوات في الجولان عام 1974 صفحة الصراع العربي/ الإسرائيلي، وتفتح، بدءا بغزو لبنان، بالتفاهم مع أميركا وموافقة إسرائيل، صفحة الصراعات العربية/ العربية المفتوحة بالفعل على مصراعيها منذ ذلك التاريخ، ويرجّح أن تبقى مفتوحة إلى أن يشاء الله، بدعم من إيران التي تدرك أهمية هذه الانعطافة في نجاح خططها، وما ترتب عليها من تصعيدٍ غير مسبوق لخلافات العرب وتناقضاتهم، ضمن ما يسمى مجالهم القومي، ومن توفيق إيراني بالنسبة للاختراقات المذهبية التي عاشتها مجتمعاتهم، وأخضعتها لاحتلال داخلي، نموذجه حزب الله الذي أسسه عام 1982حافظ الأسد، بالتعاون مع قاسم سليماني، فكانت أول إنجازاته القضاء على “المقاومة الوطنية اللبنانية” التي قدمت مئات الشهداء والجرحى والأسرى، في معارك خاضتها ضد إسرائيل في بيروت وجنوب لبنان، وإخضاع لبنان لإيران، وكيلا محليا لها، وفصيلا مسلحا تابعا لحرسها الثوري، يقوم بالمهام التي كان سيقوم بها، لو احتل لبنان.
قال حافظ الأسد عام 1967: لا أهمية للأرض الوطنية، ولا ضير في التخلي عنها، إذا تطلب إنقاذ “النظام الوطني التقدمي” إحباط مؤامرة العدو الخارجي. وفي عام 2011، عام الثورة السورية، قال ابنه بشار في عشرات البيانات: لا أهمية للشعب، في حال تطلب الأمر إحباط مؤامراته باعتباره عدوا داخليا، ولا ضير في التضحية به وإبادته وتهجيره من وطنٍ لم يكن يوما وطنه. وفي الحالتين: لا أهمية لغير النظام الذي أحبط خطة إسقاطه على يد العدو الصهيوني عام 1967 التي تولى تطبيقها منذ عام 2011 شعب سورية الخائن، بالتواطؤ مع تل أبيب وواشنطن، فهل يلام الأسد الأب أم يشكره، لأنه سلم الجولان، لكي يحبط عدوانا استهدف الثورة والقضاء على نظامها؟ وهل يلام الأسد الابن أم يشكر لأنه يبيد شعبا خائنا وغير سوري، يدّعي المدافعون عنه من الصهاينة وعملائهم أنه قام بثورة من أجل الحرية، مع أن هدفه تحقيق ما أعجز أبوه الصهاينة عن بلوغه عام 1967: ضرب الثورة وإسقاط النظام. أليست الصلة واضحةً بين عدوان حزيران الخارجي وعدوان الثورة السورية الداخلي على الأسدية ونظامها، وهل أجبر العدو الداخلي النظام على شن الحرب ضده، إلا ليستقوي بشركائه في المؤامرة، ويستعين بهم لإسقاطه.
… والآن، ما هذا النظام الذي يتآمر شعبه عليه مع أعداء تخلت قيادته لهم منذ خمسين عاما عن أرض وطنية، قوّض احتلالها الدولة السورية، وألفى أحد أركانها: سيادتها على إقليمها، وتعايش بسلام وأمانٍ مع محتليها وتجاهل تهويدها، وحجته أن استعداداته لم تكتمل، بسبب شدة المعارضة الداخلية وضعف الدعم العربي، متناسيا الفترة الطويلة التي تفصلنا عن سقوطها،
“لم يكن نصف القرن كافيا لتحرير الجولان، لكن سويعاتٍ قليلة كانت كافيةً لاتخاذ قرار بشن حرب ضارية ضد منظمة تحرير فلسطين، استمرت خمسة عقود” وانفراده المطلق بحكم سورية شموليا خلالها، في حين انقض من دون إبطاء، وبجميع ما لديه من سلاح على شعبه، بمجرد أن طالبه سلميا بإصلاح أحوال العباد والبلاد؟ وما هذا النظام “المقاوم” الذي يتخلى، منذ خمسين عاما عن أرض وطنه، على الرغم من اعتراف القانون الدولي بحقه في تحريرها بمختلف الوسائل، وانصرف إلى احتلال لبنان، وسط إدانات دولية متلاحقة، وقاوم إخراجه منه طوال ثلاثة عقود، نزلت سنوات الانتداب الفرنسي بالمقارنة معها بردا وسلاما على قلوب اللبنانيين؟ وهل سبق لنظامٍ أن احتل أراضي دولة مجاورة، بحجة تحرير أرضه، من دون أن يقاومه من يحتل هذه الأرض أو يمنعه من غزوها، بما يمتلكه من تفوق عسكري ساحق عليه؟ وهل يعقل أن إسرائيل تساهلت فيما يتعلق باحتلاله لبنان لتمكّنه من تحرير الجولان الذي ضمته عام 1981 رسميا إلى أراضيها؟
لم يكن نصف القرن كافيا لتحرير الجولان، لكن سويعاتٍ قليلة كانت كافيةً لاتخاذ قرار بشن حرب ضارية ضد منظمة تحرير فلسطين، استمرت خمسة عقود، بدعم “جمهورية إيران الإسلامية” التي أيد عدوانها على العراق: البعثي والعلماني مثله. أخيرا، هل تحرير الجولان يتحقق من خلال تدمير دولة ومجتمع سورية، وقتل شعبها وترحيله من وطنه؟ الغريب أن العدو الصهيوني لم يبادر إلى اغتنام الفرص الكثيرة التي أتيحت له لإسقاط النظام، خلال هزائمه أمامه والثورة الداخلية العارمة عليه، بل سارع إلى إبلاغ واشنطن وعواصم أوروبية عديدة، أنه لا يقبل بديلا له، فهل كان الصهاينة ليفعلوا ذلك، لو كان حقا ما يدّعيه: نظام وطني وتقدّمي وثوري ومقاوم؟ والآن، وبعد هذا الشرح المقتضب، قولوا لي بربكم: لماذا تعاديه الصهيونية والإمبريالية، إن كان يسلمهم كلما هجموا عليه أرضا سورية جديدة، ويقوم منذ ستة أعوام بما كان تحقيقه مستحيلا بيد “العدو”: القضاء على دولة سورية ومجتمعها، وشطبهما من علاقات القوة في المنطقة بأسرها، وليس فقط على حدود الجولان وفلسطين؟ تُرى، كم كان بلوغ هذا الهدف سيكلف جيش إسرائيل، وكم كان سيبقى من عمرانها لو خاضت هي الحرب؟ وهل كان نجاحها سيبلغ المدى الذي وصل إليه تدميرهما على يد نظام “المقاومة والممانعة”؟
إذا كانت النظم تحافظ على أرض وطنها وسلامة شعبها، بأي معيار وطني أو إنساني، يراد لنا أن نسمّي الأسدية نظاما، وأن نعتبرها وطنية، إن كانت قد تخلت عن أرض الوطن، وقضت أو كادت على الشعب؟ ومن غير إسرائيل أفاد من هذا ال”لا نظام”، الذي اعتدى على لبنان وفلسطين والعراق، وقتل شعب سورية؟! ولماذا تعاديه إسرائيل، إن كان تدمير سورية والمشرق يكفل تفوقها الاستراتيجي على جيرانها لنصف قرن مقبل، ستكون في أثنائه سيدة المنطقة، وستتمتع بقدرةٍ مفتوحة على التدخل فيها، وستلتهم فلسطين من دون أن يغضب ذلك من سيسارعون إلى مصالحتها من العرب، بعد تحولها من قوة محلية وازنة إلى قوةٍ فوق إقليمية، أثبتت قدرتها على حماية الأسد من شعبه، بنفوذها الدولي وسماحها بتدفق عشرات آلاف المرتزقة على سورية من أجل الدفاع عنه، ولو أنها حالت دون ذلك لكان الآن في خبر كان، ولانتصرت ثورةٌ رأت تل أبيب فيها خطرا داهما على ضامن أمنها الأسدي الذي قبل، منذ 1974 ميزان قوى وضعه تحت إبطها وفي خدمتها.
المصدر : العربي الجديد