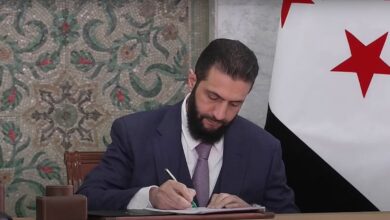يعرف صانع الأفلام، جون غريسون، الفيلم الوثائقي بأنه “العلاج الإبداعي للواقع”، أو أنه “إمكانية السينما من مراقبة الحياة وتصويرها، بحيث يمكن استغلالها في شكل جديد للفن”. وقد يكتشف العالم له تعاريف جديدة، وأكثر رعبا، حين يسقط الطغاة المنتصرون، وحين يسمح للضوء، وللكاميرا، بالدخول الى ما تحت الأرض، هناك حيث الموت لم يزل يربي صغاره جيدا، وحيث الحياة/ الأم/ تغتصب أمام قلوب أبنائها، وتضرب مدار الساعة، مدار القهر، وحيث تموت الحياة تحت التعذيب.
“الصرخة المكتومة” فيلم وثائقي فرنسي عرضته القناة الفرنسية، قبل أيام، وصعق الرأي العام الفرنسي كما كتبت الصحافة. وذكرت “لوموند” أن الشعب الفرنسي لم يكن يعرف شيئا عن مدى فظاعة ما يحدث في سجون النظام في سورية، وأن الفيلم جعلهم يسمعون صوتا لم يتخيلوا أنهم قد يسمعونه يوما، بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية، وانتهت معها سجون النازية ومعسكرات الاعتقال والمحارق البشرية. ولكن كيف يكون الفيلم صاعقا إلى هذه الدرجة؟ وكأن العالم لم ير الصور التي نشرها “القيصر” لأحد عشر ألف معتقل ماتوا تحت التعذيب، ولم يسمع قصص اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا، ولم ير آثار التعذيب على أجسادهم وقلوبهم.
كيف تصف الصحافة الفيلم صادماً؟ وكأن العالم الذي لم ير نظاما يقصف مدناً بالبراميل، ولم يشاهد أقدم مدن العالم وقد صارت مدناً للخراب والموت، ولم يعرف نظاماً يقتل في سجن صيدنايا وحده خمسة عشر ألف معتقل، ويخفي قسريا ما يزيد عن ستين ألف اسم. كيف لا يعرف العالم ما يحصل في سورية، مع أن منظمة العفو الدولية، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، تقدّم للعالم كله تقاريرها المرعبة عما يحصل في سورية سنويا؟
هل كان الرأي العام الفرنسي، والعالمي، بحاجة إلى هذه “الصرخة المكبوتة” كي يسمع صوت قطرات المطر على زجاج واجهة السيارة في بداية الفيلم، والأضواء البعيدة القادمة، طريقة التصوير الذكية، الموسيقى التصويرية المؤثرة؟ كل هذه تقنيات تنم عن مهنيةٍ وحسّ عاليين، مثلما تنم عن قدرة إخراجية حقيقية، لكن البطل الذي جعل الفيلم ينجح، وجعله يدخل البيوت والقلوب من دون جواز سفر، هو الصوت الصادق الطالع من الكبد، والذي بدأ منذ أكثر من ست سنوات في الساحات، قويا، أخضر، واثقا، مفاجئا، شغوفا، والذي خانته السماء، وخانه العالم، وخانته الحناجر، لينتهي في الفيلم صوتا ذليلا، مخذولا، كصراخ امرأةٍ ثائرةٍ تغتصب.
هذا البطل الذي أخذ دور البطولة اليوم للمرة الأولى، في فيلم وثائقي عن الصوت، قد يكرّمه العالم ويعطيه جوائز، ليصبح الوجع السوري من جديد صياد الجوائز الماهر. وقد تكرّم المخرجة المشكورة على حقيقية سعيها وتحدّيها، وتكرم الصحفية التي سعت إلى إنجاز المقابلات، ويكرّم منسق الموسيقى التصويرية، والمصور. ولكن من يكرّم مريم؟ من يعيد إليها نفسها التي سقطت منها؟ ومن يعيد لتلك الأم الباقية المقتولة/ الناجية من مجزرة الحولة، ملامحها وأبناءها الذين دفنتهم في التراب؟ والأهم من هذا كله، هل سيستطيع هذا البطل أن يكون بطلا، ويخرج امرأة، أو شابا، أو طفلا واحدا، من الثلاث مائة ألف معتقل ومعتقلة الذين لم يزالوا هناك، والذين، في كل لحظة، بكل ما بقي فيهم من صوت، يصرخون؟
استطاع “الصرخة المكتومة” الصراخ الحقيقي عالياً، حتى حدود السماء التي آن لها أن تكسر صوت “مريم” ممرضة الإغاثة الجميلة، ذات العيون الواسعة والقلب المثقوب، مريم التي رمتها الثورة في قلب مشفى ميداني، كي تنقذ ما تبقى من الأرواح، وكان عليها أن تدفع روحها عقابا لما اقترفته من جرم إنقاذ الحياة. كان صوتا قادما من أعماق بئر سقط دلوه فيه، وانقطع الحبل، ولم يبق منه غير صدى السقوط، صوتها وهي تعيد تفاصيل ليلتها الأولى في المعتقل، بكل ما يحمله من رجفات الحقيقة، ومن تهدّج قسوتها، بكل ما فيه من أنوثة مكسورة، ومن كبرياء طافح بالوجع، استطاع صوتها هذا اختراق كل القلوب التي سمعتها، واستطاع ثقبها، وصفها نفسها، ولصديقتها، وهي عارية تغتصب اغتصابا جماعيا حيوانيا. أما عيون الأم القادمة من الحولة، والتي قتل أولادها أمام عينيها وقلبها، الأم التي تصفع بعيونها، وهي تبكي، كل جباه البشرية، والتي غنت في نهاية الفيلم أغنية مسننة الحوافّ، جرحت أصابع العدالة، وفقأت عين التاريخ الباقية.
هل سيستطيع أحد، أي أحد، أن يواجه هذه العيون، وأن يخيّب ظن مريم التي قالت إنها تعرف أن الفيلم لن يغير شيئا، وأن الجميع سوف يشاهدون، ثم يحزنون، ساعة أو أكثر قليلا، ثم ينسون كل شيء. ويتركون الإنسانية وحدها هناك، تغتصب اغتصابا جماعيا، كل ليلة.
المصدر : العربي الجديد