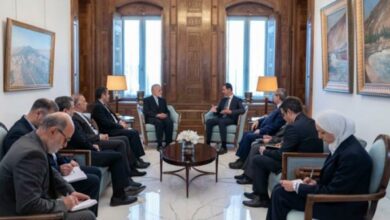للصراع السوري طوال خمس سنوات خاصية نادرة، قد لا يكون ثمة ما يشابهها في ثورات وحروب دول وحروب أهلية أخرى. ولا شبه لها حتى في الأقرب إلينا من صراعات كالحرب اللبنانية والحرب العراقية والحرب الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين، مجتمعاً وأرضاً: لم تتح للسوريين خلال خمس سنوات طويلة فرصة يوم واحد لالتقاط الأنفاس، للنظر في ما حولهم وتفقد أنفسهم وجيرانهم، لتقييم وضعهم، وجوهرياً للقيام بحداد وفتح صفحة جديدة.
لم يمر يوم واحد، خلال نحو 1860 يوماً من دون وقوع ضحايا، بين آحـادٍ كل يـوم في بداية الثورة، إلى عشرات طوال معظم سنواتها، وإلى مئات في بعض مذابحها، وإلى نحو 1500 في الغــوطة وحــدها في يــوم من أيام آب (أغسطس) 2013، إلى ما بين أحاد وعشرات كل يوم بعد «وقف إطلاق النار» قبل نحو شهرين. وهذا في عشرات مواقع البلد كل يوم، وعملياً في كل منطقــة خارجة على سيطرة النظام، ودومــاً مع دمار واسع.
نحن في حاجة عامة ملحة إلى حداد، لنودع من رحلوا، ونتصالح مع فقدِنا، ولنبدأ في التعافي، أفراداً وأسراً وبيئات اجتماعية وبلداً. في الحداد لا نأسى على من فقدنا فقط، ولا نجتمع للتواسي فنوثق رابطتنا الاجتماعية فقط، وإنما نعلن أيضاً انتهاء الفقد بوداع الفقيد، ثم العودة إلى «الحياة الطبيعية». نحن لم نحُدّ لأن الفقد لم ينتهِ، ولم نجتمع ونتواس لأن الدم لا يزال يسيل، ولم نشرع بجديد لأن الصفحة القديمة لم تطوَ. يتجمع موتانا في داخلنا، وتتحول نفوسنا إلى أحياء مدمرة، ولا نتلقى أي عون من أجل الانفصال عن الموت والدمار. والقاتل العام معروف الاسم والعنوان، مقيم هناك، وهو يبدو اليوم محصناً من عقاب واجب أكثر من أي يوم مضى.
ككسر لإيقاع الحالة العادي وتفرغ وقتي لوداع من ماتوا، الحداد يحمي أيضاً التمايز بين الحياة والموت، فيسهم في صون حرمة الحياة وحماية الأحياء. هذا لم يتسنَّ للسوريين، ليس على الصعيد الجمعي وحده، ولكنه قلما كان متاحاً حتى على صعيد الأُسر، لاستحالة إقامة جنازة لائقة حيناً، ولمنع الجنازة أحياناً (معظم من سلمت جثثهم ممن قتلوا تحت التعذيب في مناطق سيطرة النظام)، أو تعذر جمع جسد القتيل أو القتلى ودفنهم، أو تفرق الأسرة بين البلدان، أو إيقاع القتل اللاهث الذي لا يسمح باكتمال الانفصال عن راحل قبل أن يتلوه آخر.
ما وقع على الصعيد العام، بالأحرى، هو عكس الحداد إن كان للحداد من عكس: تسيير عادي جداً، مبتذل، لـ «الأزمة»، يمنع معاقبة القاتل ووقف القتل طوال خمس سنوات، ثم يضغط اليوم على أهالي المقتولين بكل السبل كي يقبلوا بالابتذال مخرجاً من صراعهم التراجيدي، حتى من دون أدنى ضمان بوقف القتل.
هذا هومعنى جنيف.
ما هو الخطير في ذلك؟ فوق التسليم بالعدد المهول من الضحايا، وبأنهم سقطوا من أجل لا شيء، هناك أيضا حرمان تضحية السوريين من أن يكون لها أي معنى عام، ولو حتى «قيمة قربانية»، على ما يقول جيورجيو أغامبن عن «الإنسان المباح». يساعدنا المعنى على أن نتحمل رحيل من رحلوا وننسب إلى رحيلهم قيمةً وشأناً: لقد كانوا قرابين للحرية، لسورية الجديدة، للترحيب بالمستقبل والتخلص من قوى وأجهزة القتل القديمة. عبر الفصل بين صراعنا المرير والمعنى، نخسر قضيتنا ومعنانا، فوق خسارة شهدائنا ودمار بلدنا وتحطيم مجتمعنا وتهجير نصف السكان في الداخل والخارج، ونقبل أن كل هذا راح هدراً.
كان أول التجريد من المعنى هو فعل التسمية. وُصِف صراعنا بأنه «أزمة»، «حرب أهلية»، «صراع طائفي»، ما يعني أن الأمر يتعلق بصراعات غير عقلانية بلا معنى، تنشب بين أناس غير عقلانيين، ويجب أن تتدخل القوى الدولية النافذة لتسويتها. من يفرض التسمية يقرر التسوية، ويمحو الفارق بين القاتل والضحية، فلا يعاقب ذاك، ولا يحد على هذا.
لكن بالإصرار على مخرج مبتذل من صراعنا وبحرماننا من حداد، فإننا لا نحرم فقط من الأسى على ضحايانا والتواسي في ما بيننا، ولا من التضامن الذي قد نلقاه من شركاء لنا، وإنما كذلك من إعلان وقف الفقد أو انتهائه، وما يعقبه من تكيف مع الخسارة وإعطاء أنفسنا بداية جديدة. الحداد مستحيل من دون معاقبة القاتل، ومن دون حداد يحترم الضحايا ويودعهم، يجري إغراق التوقف المحتمل للصراع في العادية والابتذال، فيكون هو ذاته توقفا مبتذلاً هشاً، فلا يكون هناك فرق مهم بين توقف واستمرار، بين سلم وحرب، بين صراع ولا صراع، وبين بداية ونهاية. وفي ذلك قلة احترام لصراعنا ولضحايانا، ولا مبالاة كاملة بحياتنا وموتنا.
وقف إطلاق النار الساري منذ ما يقارب الشهرين هو من هذا الصنف. والعملية السياسية في جنيف لا تعدو كونها إدارة لـ «الأزمة»، مؤداها نقل الصراع السوري من «أزمة عالية الحدة» إلى معتدلة أو منخفضة الحدة، حسب التعبيرات المبتذلة لمراكز أبحاث غربية. إدارة الأزمة تقتضي بقاء الأزمة، والاحتفاظ بمنابع التأزم من أجل أن يحتفظ المديرون بموقع مهيمن، يتحكم بتفاعلات «هذه المنطقة المتأزمة من العالم».
من دون عقاب ومن دون حداد، يتمّ تبديد الأثر التأسيسي للصراع، وتجريد موت السوريين، وتالياً حياتهم، من القيمة.
انفراد الصراع السوري بامتناع الحداد الفردي والجمعي طوال أكثر من خمس سنوات لا يعزله عن نسق مطرد لكل ما رأينا من تسويات لصراعات الإقليم، منذ نهاية الحرب العالمية الأولى إلى التسويات الفلسطينية، إلى التسوية اللبنانية، إلى التسوية السورية التي يتمّ طبخها من قبل أقوياء غربيين وروس لمصلحة غربيين وروس وإسرائيليين، وشركاء محليين للثلاثة. هذا النسق يتمثل في ابتذال التسويات قياساً إلى مأسوية الصراعات، و»نجاح» التسويات الثابت في ألاّ تطوي صفحة الصراعات التي يفترض أنها تُسويها. هذا النسق يتمثل جوهرياً في الحرمان من العدالة ومنع معاقبة المجرمين، بل مكافأتهم أحياناً (إسرائيل دوماً). ومؤدى النسق هو حرمان الضعفاء عملياً من أن تكون لهم سيادة، وبالتالي سياسة. وفي العمق حرمانهم من أن يكون لهم كرامة وتاريخ.
محصلة هذه العمليات التي تفصل بين السلم والعدالة استحالة السلم عملياً، والعيش في شروط من الحروب المتكررة التي تعالج بتسويات من الصنف المبتذل نفسه، يشترك فيها وكلاء مبتذلون للنظام الدولي، ما يؤدي إلى انحطاط السياسة في المنطقة، وإلى أوضاع مثل القائمة اليوم، تجمع بين صفتين متناقضتين: الإعضال والابتذال، مزيج من الاستحالة والتفاهة. أليس المستحيل التافه أو التفاهة المستحيلة هي جوهر بشار الأسد وممثلي نظامه جميعاً؟ ابتذال وتفاهة، وسفاهة في الواقع، تحظى بتغطية من نظام دولي لم يمتنع عن حماية السوريين فقط، وإنما هو يوفر رصيد قوة وحماية مضمونة لقتلة تافهين. كان ممثل النظام، الجعفري، يُشبِّح بكل سفاهة في جنيف، ولم يظهر مسؤول دولي واحد ليقول بكلام واضح: إن هذا غير محترم وغير مقبول!
وغير انحطاط السياسة، انحطاط الثقافة. شرط التفاهة المستحيلة المديد، المفروض قسراً، ينعكس في أذهان «مفكرين» عندنا، خصوصيةً للمنطقة ومجتمعاتها وثقافتها وعقلية سكانها. وهو ما لا تكف عن نشره وتعميمه أيضاً مراكز أبحاث وخبراء غربيون. يغيب كل ما له علاقة بالسيادة، بالقوة الفعلية، بالتحكم بحياة عشرات ملايين أو مئات ملايين البشر، باستثناء الإقليم من العدالة، بحصانة مكفولة دولياً لقتلة السكان المحليين. وتبدو التفاهة المستحيلة التي صنعت شروطها خلال قرن نتاجاً تلقائياً لتكويننا، ويبدو سحق مقاوماتنا وتجريدها من المعنى انعداماً ذاتيا لمعنانا. هذا التفكير أسوأ من أن يكون خطأ، إنه مساهمة الابتذال في الثقافة والفكر، مساهمة في ألا تكون هناك ثقافة وفكر ولا بعد ألف عام.
مساهمة أيضا في تغذية شروط الحرب المستمرة التي تدوم أجيالاً أو قروناً. قد يكون الصراع السوري علامة ولوج زمن وحشي من العنف القاتل المغطى دولياً، من تسهيل أمر التخلص من الضعفاء من دون حداد بكفالة دولية، ومن الابتذال واللامعنى المفروضين دولياً بدورهما.
أكثر ما تلح الحاجة إليه هو القطع مع هذا المسار، الخروج من تناسل التفاهة المستحيلة الذي لا ينتهي، والدخول في المأسوي، حيث هناك حداد على الضحية وعقاب للمجرم، وحيث السلم سلم والحرب حرب، وحيث هناك كرامة وعدالة وسياسة. وتاريخ.
هذا شيء يمكن، ويجب، أن نعمل على تحقيقه في الفكر والفن والثقافة، اليوم ودوماً.
المصدر : الحياة